عبد القادر العرباسيّ شاعر يكتب القصيدة النثريّة الفصحى والقصيدة العاميّة، وهو، من خلال تعرّفي عليه، من رهط الشعراء والكتّاب الكُثر الذين غُمط حقّهم في الانتشار “تواضعا” و- “قلّة خبرة في تدافع الأكتاف”. وحين توجّه إليّ ملقيا بين يديّ إنتاجَه هذا (الثالث) طالبا رأيي المكتوب وأكثر، ورغم حقيقة أن ليس من الهيّن أن يكتب كاتبّ ليس بناقد عن شاعر، قبلت الحمل رغم ثقله بعد تردّد وإقبال. ووجدتُّني أعود إلى مقال كنت كتبته قبل سنوات تحت عنوان: “ملاحظات قاريء… “النقّاد الأوائل” بين الإفراط والتفريط!”، كتبت فيه:
“معياري ومقياسي في تقييم ما أقرأ ببساطة: أن النص الأدبيّ يبلغ المراد إن نزل إلى القاريء صاعدا به لا نازلا “طلسمة” عليه، وفاعلا فيه أي فعل، كأن يسعده أو يتعسه، يضحكه أو يبكيه، يثوّره أو يهدئه، يفرحه أو يحزنه، يمقِته أو يسرّه، يفيده أو يضرّه، يحرقه أو يطفئه، يغضبه، يستفزّه أو خليط من كل أو بعض هذا. وباختصار يحرّك شيئا ما فيه طبعا دون أن يكون “مبهدل” الجوهر واللبوس فلكل شيء في الدنيا قواعد… مسؤوليّة المقدّم وهو “الناقد الأول” المؤتمن على العمل الذي وُضع بين يديه، لا حدود لها تجاه من ائتمنه وتجاه القراء، ومن هنا فالإفراط في المديح خطأ يُغتفر وأما التفريط في الأمانة فخطيئة لا تُغتفر…”
الحقّ أقول: أن عبد القادر وحين ألقى بين يديّ هذه المجموعة الشعريّة، توجّهَ لي بما معناه: “خذ حريّتك ولا تداري”، ما من شك أنه بتوجّهِه الواثقِ هذا بما يكتب وبي زاد عليَّ الحملَ ثقلا، أتمنى ألّا ينوءَ بي وألّا أنوءَ به.
المجموعة هذه عبارة عن قصائد نثريّة، وأخرى بالعاميّة، وثالثة ب-“العاميّة الشعبيّة” لا يستطيع أن يدّعي الشاعر أن الأخيرة ليست كذلك حتّى لو كانت كلماتُها كلماتِه، ف- “يا ظريف الطول” تبقى شعبيّة حتّى لو عُرف واضع كلماتها.
اقترحت على الشاعر أن يستغني عن القصائد الفصحى في المجموعة، اللهم إلا تلك التي استطاع أن ينتقي كلماتها بقدرة يُحسد عليها، جعلت منها قابلة للقراءة بالعاميّة كذلك. (قصيدة “تعالي” مثلا)، لتبقى المجموعة عاميّة وعاميّة شعبيّة دون هذا الخلط وليحفظ الفصحى منها لإنتاج خاص. ورغم ذلك وانطلاقا من أن اقتراحي يمكن ألّا يُقبل، ولا ضير في ذلك، و-“استغلالا” لتوجهه آنف الذكر، اقترحت عليه ما استطعت إلى ذلك قدرة وسبيلا لُغويّا وقواعديّا ونصيّا في الفصحى منها، والعاميّة انطلاقا من أن العاميّة لا تمنحك “صكّ غفران” مفتوحا، فأدليت دلوي في بئريهما حيث حتّم الأمر وكان ذلك كثيرا نسبيّا، وكان الشاعر يستطيع التقليل من تلك الكثرة لو تمهّل في بعض المواقع وفعّل المراجعة المطلوبة.
الشاعر ورغم الرأي السائد في القصيدة النثريّة بشكل عام وفيما يخصّ التقفية بشكل خاص، وبكلمات الكاتب العراقي د. عدنان الظاهر في موقع ابن خلدون:
“لا ديكورات فيها ولا توظف أيا من المحسنات البديعية ولا يخضع نمط التفكير فيها لقوانين الفكر المعروفة وأحكام المنطق السائد. الشاعر يرسم أجواء قصيدته وفق منظوماته الفكرية الخاصة وحسب متطلبات منطقه الخاص الذي يبدو للقارئ وكأنه (لا منطق) أو أنه (ضد المنطق). لكل شاعر عالمه الخاص الذي لا يضاهيه أحد فيه… الكثير من مفردات القصيدة الداخلية قابلة للقراءة من غير حركات. سكون شبه كامل وقصيدة بلا حركات. وبهذا فإنها من بعض الوجوه شبيهة بقصائد الشعر العامي، شعر اللغة المحكية والدارجة. القصيدة تبدو كعالم هامد مسطح يفتقر إلى جهاز تنفسي، لأن في التنفس يتحرك الصدر إلى الجهات الأربع. حركات الإعراب في لغتنا هي حقا ومجازا عمليات تنفس تتحرك الكلمات معها وفيها فتمنحها نسمة روح الحياة ودفء دماء الجسد الحي الجارية.” وأضاف بومضة مشعّة:
“لعل أحد أكبر الفوارق التي تميز قصيدة النثر عما سبقها هو الشكل. فهي بلا شكل، إنها مثل حيوان الأميبا الذي يمكنه التمدد إلى كل الجهات. إنها قصيدة أميبية الشكل. وإذا كان الماء يتخذ شكل الإناء الذي يحتويه فان قصيدة النثر ماء بلا إناء!!”
شاعرنا ورغم هذا الرأي في القصيدة النثريّة، فقد قفّاها. ادّعِي أن تحرير القصيدة النثريّة من القافية ليس معناه تحرير الشاعر من حريّته أن يقفّي إذا أراد، وأضيف ادعاء إنه إذا قرّر ذلك فليس معنى هذا أن يحرّر نفسه في القوافي من موجبات اللغة و- “سكّن تسلم”. هذه “الحريّة” لم يستعملها شاعرنا، وحسب رأيي، استعمالا صحيحا في غالبيّة قصائده حاسبا أن في التسكين ما يعطيه حقّا بذلك وأنا أعتقد أنه لا يحقّ له ذلك. (أبرز مثالٍ قصيدته “أمامي مدى”). إضافة فإن اختيار الأحرف وحركاتها هو أمر في غاية الأهميّة تعبيرا عن الصورة الشعريّة، ولعلّ في بيت شعر البحتريّ في وصف الذئب الذي التقاه أبرز الأمثلة: “يقضقض عصلا في أسرّتها الردى – كقضقضة المقرور أرعده البردُ”. انطلاقا من ذلك فتحريك القوافي في قصيدة “أمامي مدى” كان ليعطيها قوّة أكثر، غير أن التزام القافية صعّب المهمّة عليه فهرب إلى التسكين إعفاء لنفسه من القواعد، وبالمناسبة الأمر ما زال قابلا للتدارك، هذا الأمر بارز كذلك في قصيدة “تشاؤم تحت وطأة قهر مزمن”.
ومع هذا ورغم كلّ ذلك، وإذا انطلقت من “قاعدتي” التقييميّة (التقويميّة) أعلاه كقارىء ليس بناقد، فنحن أمام شاعر وإن كان لا يُغفر للشاعر إهمال “اللبوس” تحت شعار “أنا أكتب ما يخطر في البال دون اعتبار المرجعيّات…”، وكان ذلك بارزا في الكثير من المواقع، ولكن من الجانب الآخر فإن قصائده جوهرا قد فعلت فيّ فعلها ودون طلسمة، فقد أفرحني بعضها وأحزنتني أُخر واستفزّتني ثالثة وأحرقتني وأطفأتني غيرها، وأعتقد أنها ستفعل ذلك في كلّ قارىء. ولعلّ في فاتحة المجموعة مؤشّرا:
- قصيدة “موسم حصيدة” والتي استهل بها مجموعته وفيها يقول:
“أنا بيت شعر
أنهكته تفاعيل وجهك القمحيّ
وانفلت من أسر القصيدة.
فأتيتك حاملا منجل الأحلام،
وقد امتلأت سنابلك بالحبّ
وآن موسم “الحصيدة”.
- وقصيدته “رسالة” من أب يعتذر عن فقره لابنه قمّة في الإنسانيّة.
- وهكذا “أمامي مدى” وهو هنا شعبه.
- وحين يتغزّل كما في قصيدة “التقيتك ع طريق الواد” نراه يرسم صورا في غاية الجمال.
هذا غيض من فيض ما جادت به قريحة الشاعر عبد القادر في مجموعته هذه. ويظلّ السؤال الذي أشغلني ومنذ أن تحرّرت قليلا من العمل السياسيّ الحزبيّ وصرت أعطي أكثر وآخذ أكثر لِما ومّما أحببت أكثر، الأدب: لماذا ظلّ أمثال عبد القدر من المبدعين، وهم أكثر من كُثر، في الظلّ كلّ هذا الزّمن؟!
مع أني كتبت الكثير في هذا السياق وأدّعي أنّي كشفت عن جوانب كثيرة من الجواب، لكني هنا أترك أدعو القارىء أن يبحر في “بحور” قصائد الشاعر، ولا أشكّ أنه سيشاركني الإجابة ويدعّمها، فهو في نهاية الأمر العنوان، وأكبر من كلّ الحواجز، وهو سيّد الألِبّاء، وليس مطلوبا من عبد القادر أن يتنازل عن تواضعه ولا عن مفاصلِ أكتافه وما سخّرهما له العمرَ، حتّى لو “استُلِدّوا”!!
سعيد نفّاع
أوائل تموز 2018
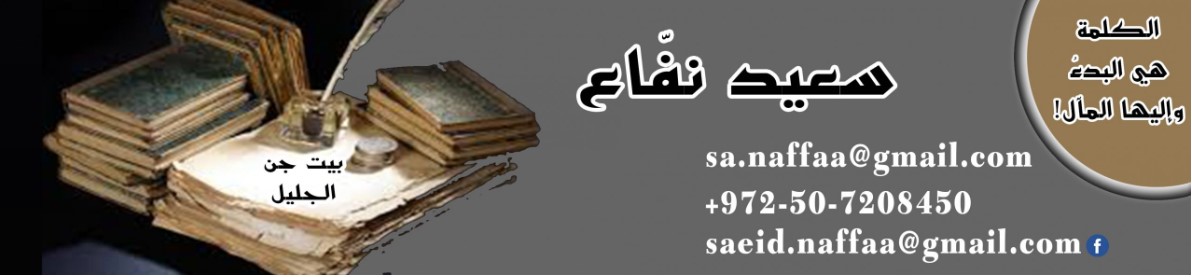 سعيد نفاع
سعيد نفاع