الحركة التقدّميّة للتواصل – درب المعلّم
1_ الرؤية
التواصل الأهلي والمذهبي والوطني والقومي في ظلّ الانتماء العربي المنفتح والإنساني.
(العرب الدروز و\أو طائفة المسلمين الموحّدين الدروز و\أو الطائفة العربية الدرزية مجموعة ذات هوية واضحة تعتز بانتمائها الوطني والقومي العروبي المنفتح والإنساني، تتواصل فيما بينها ومع محيطها العربي المحلي والإقليمي، مؤثرة في المجال الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي على كافة المستويات، محليّا، إقليميّا وعالميّا.
الهويّة والانتماء العربيّين للدّروز في البلاد كانتا الفريسة الأولى التي تمّ الانقضاض عليها، ونُشبت فيها الأنياب ومزّقتها شرّ ممزقٍ، ولم تستطع القوى المقاوِمة رغم ملاحمها الكثيرة والكبيرة أن تشكلّ ندّا للمؤسسة خصوصا وأن ميزان القوى لم يكن مرّة في صالحها، ومن الصعب أن يكون في صالحها في المعطيات الموضوعيّة القائمة المتوفرة.
2_ الخلفيّة
أ_ التواصل فكرة وممارسة
“التواصل” بين الناس، كقيمة إنسانيّة، يتربّع في الصف الأوّل بين القيم التي عرفها الإنسان ك- “حق طبيعيّ”، بسلوكه الفطريّ بدءا ولاحقا بأدواته الحياتيّة، العُرفيّة والتوافقيّة- الاتفاقيّة ومن ثمّ الشرعيّة والقانونيّة، وكهذا فهو، في هذا السياق، أعلى مرتبة من كل حقّ وضعي آخر مكتسب.
“التواصل” لغة من الكلمات الأغنى معنى للعلاقات بين الناس، ويبدو أن لها وقعا جيّدا على الأسماع كذلك، زيادة إلى العمق المعنوي و”التفرّدي”، وما أعطى هذه الكلمة هذه التفرديّة هو أمّها الجميلة، اللغة العربيّة. ومن الصعب إيجاد ترجمة لها إلى اللغات الأخرى تفي بالمعاني الجوهريّة التي تحتويها هذه الكلمة، فكل ترجمة نستطيع إليها سبيلا، لا تفي ولن تفي بالعمق الذي تمتاز به هذه الكلمة.
التواصل في العمق المعنوي الجوهريّ، مصدر قوة وحماية للبشر في كلّ تشكيلاتهم، الإنسانيّة العامة، والعقائدية الفكريّة، والاجتماعيّة والأهليّة. وبكلمات أخرى هو حق إنسانيّ وقوميّ ووطنيّ وعقائدي- فكري، وديني- إيماني، ومذهبي، واجتماعي – أهلي، لما في كل هذه الانتماءات طبقا للمسيرة البشريّة، من أهميّة في حياة الإنسان حفاظا على القيمة السامية العليا للبشر: الحياة.
“التواصل” في باب المنطلقات الإنسانيّة: أفضنا أعلاه، وما نودّ أن نؤكده أن التواصل كحق قيميّ لا بدّ أن ينتصر، ففي الصراع ما بين الحق والباطل، فللأخير جولات إلّا إن للأول الجولة النهائية والقاصمة، وهذا ما سيكون!
وسنتركز هنا بحق “العرب الدروز” في التواصل (أو يمكن أن نستعمل التسميات التي جاءت أعلاه). العرب الدروز بغالبيتهم العظمى يقطنون في بلاد الشام. لا إحصائيّات دقيقة حيال عددهم، والمتناقل المقدّر يحكي عن 1.5 مليون تقريبا، يتوزعون من الأكثر للأقل عدديّا، وب-“فضل” سايكس وبيكو، على سوريّة فلبنان ففلسطين (إسرائيل) فالأردن. الواقع التاريخي المعيشي قسّم العائلة الدرزيّة الواحدة بين الأماكن الأربعة، فنادرٌ أن تجد عائلة درزيّة لا يتوزع أبناؤها (قرابة من الدرجة الأولى) بين هذه الأقطار. وبحكم هذا الواقع التاريخيّ انتشرت في هذه البلاد مواقع يقدّسونها مذهبيّا، مقامات لأنبياء وأضرحة لأولياء.
على المستوى الأهليّ، لم تشكّل لا حدود الولايات أيام العثمانيين، ولا حدود الانتداب أيام الانجليز والفرنسيين، عائقا أمام التواصل الأهليّ، وعلى المستوى المذهبيّ العام لم تشكل هذه الحدود عائقا للتواصل مع الأماكن المقدسّة. واتخذ لهم الدروز تقليدا للقاء جامع أربع مرات سنويّا، أوائل الشتاء في خلوات البيّاضة (خلوات عبادة) حاصبيا – لبنان، أوائل الربيع في مقام النبي شعيب (ع) في حطين- فلسطين، أوائل الصيف في مقام النبي أيوب (ع) الشوف- لبنان، أيلول من كلّ عام أو أوائل الخريف في مقام النبي هابيل (ع) الزبداني- سوريّة. الحدود الجديدة بعد النكبة وقيام دولة إسرائيل، قطعت الأواصر وغدت تشكّل عائقا في وجه التواصل، وعلى هذين المستويين كما غيرهما.
طبعا هذا الانقطاع طال كلّ الأقليّة الفلسطينيّة فانعزلت عن امتدادها الطبيعي، قوميّا ووطنيّا وأهليّا، إلى أن رأت إسرائيل، وليس من دوافع إنسانيّة أو حفاظا على حريّة المعتقد الديني والحق في ممارسته، وإنما لأسباب سياسيّة بالأساس، لا ضرورة للدخول في تفاصيلها، أن تفتح الباب أمام المسيحيّين العرب وغير العرب (الأرمن مثلا) وقبل العام 1967م لزيارة القدس (الأردن) في أعياد الميلاد ومن هنالك أينما شاءوا. ولاحقا وبعد ال- 1967م فتحت الباب أمام المسلمين عربا وغير عرب (الشركس مثلا) لزيارة السعوديّة حجّا وعمرة. أمّا بالنسبة لليهود فلم تُغلق الأبواب مرّة وأينما شاءوا، العراق مثلا ومؤخرا حتى إلى إيران ل-“الاستلقاء” بالمصطلح العبريّ ترجمة حرفيّة، على أضرحة الصديقين هنالك.
كذلك فتحت الباب للدروز سكان هضبة الجولان السوريّة المحتلّة لزيارة سوريّة في موعد الزيارة التقليديّة لمقام النبي هابيل (ع). ولم يبقَ الباب مغلقا موصدا إلّا على الدروز الفلسطينيّين.
“التواصل” في باب الخلفيات الوطنيّة: كلّ من أتعب نفسه ودرس تاريخ الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة في أدبيّات الفريقين، الصهيوني والفلسطيني، يجد الواقعة التاريخيّة الآتية: زار فلسطين عام 1920م رئيس المنظمة الصهيونيّة حاييم وايزمان (الرئيس الأول لدولة إسرائيل لاحقا)، زيارة دراسيّة، ووجه بعدها وعلى ضوئها قسم التوجيه السياسي في المنظمة الصهيونيّة، لوضع دراسة حول الطرق التي يجب اتباعها ل-“تقبيل- من يَقْبل” الفلسطينيين الهجرة والاستيطان اليهوديّين. خلص القسم إلى استراتيجيّة مفادها، في بعض مركباتها، دق الأسافين بين شرائح الشعب الفلسطيني المختلفة ب-“فرّق تسُد”، وعام 1932م أتبعها يتحساك بن تسفي (الرئيس الثاني لدولة إسرائيل) بوثيقة خاصّة تجاه الدروز لسلخهم عن انتمائهم العربي.
بعد ال-48 استطاعت المؤسسة أن تغرز في جدار وحدتنا الوطنيّة الكثير من الأسافين، ولعلّ أشدّها وأعمقها كان ذلك الذي ضُرب بين الدروز وبقيّة أبناء شعبهم، ولاقى نجاحا كبيرا ما زالت آثاره ماثلة حتى اليوم للعيان. فإذا كانت الوحدة فعلا موطن قوّة، ولا أعتقد أن أحدا يعتقد غير ذلك، فلن يعزّزها لا خطابا ناريّا ولا مقالا بلاغيّا، لن يعزّزها إلا العمل الميدانيّ، وهذا هو التواصل الذي نحن بصدده.
وحدتنا هي سلسلة من الحلقات، وفي تعزيز وتقوية كل حلقة تعزيز وتقوية لكامل السلسلة، فعلى كل منّا أن يعزّز، أولا، الحلقة التي يعيش بحكم البيولوجيا أو الجغرافيا فيها، مانعا أن تتآكل من الصدأ ليبقيها مكينة لا تنقطع، فتبقى السلسلة متواصلة. “الحلقة الدرزيّة” في بلادنا انقطعت، حقيقة كل من ينكرها فهو متغافل في أضعف الإيمان، والأسباب متعددة ذاتيّة ووطنيّة وسياسيّة لسنا في صددها الآن. حقيقة أخرى هي أن كل المحاولات السابقة لدرء الصدأ عن الحلقة، رغم الجهود المباركة والكبيرة لم تحقق النجاح المطلوب. “التواصل” كمشروع يتوخى أن يعيد للحلقة سلامتها ومكانها في سلسلة وحدتنا الوطنيّة.
“التواصل” في باب الأسباب الاجتماعية: التهديد الأعظم على وجودنا في بلادنا بكل أطيافنا، هو ليس الوجود الفعلي الجسدي (الكينونيّ)، فهذا حُسم ولا مكان ولا إمكانيّة، ورغم التهديد الكامن بالترحيل، أن يُمسّ هذا الوجود بوجهه هذا، فنحن حقيقة أبديّة. ولكن هذه الحقيقة الأبديّة كانت وما زالت كابوسا مؤرّقا ولذا يُستهدف شكل هذا الوجود بشتى السبل لجعله وجودا متخلّفا، مشوّها بالطائفية والحمائليّة والعنف وكل الآفات.
“التواصل” في باب الأهداف الفكرية: استعباد أيّة مجموعة بشريّة على يد حاكم ظالم، يتأتى بقطع جذورها الحضاريّة، تواصلها الحضاريّ، وجعل لقمة عيشها في أيدي ذاك الحاكم وأدواته، وإتخام المأجورين في المجموعة حتى “الثمالة” على يد هؤلاء الحكّام. هذا تماما حال العرب الدروز في البلاد، والتفاصيل كثيرة كُتب فيها الكثير وقيل الكثير، ولا حاجة للعودة عليها في سياقنا هذا، فالمعنيّ يستطيع أن يجد الكثير من الأدبيّات في هذا الموضوع.
الهويّة والانتماء كانتا الفريسة الأولى التي تمّ الانقضاض عليها، ونُشبت فيها الأنياب ومزّقتها شرّ ممزقٍ، ولم تستطع القوى المقاوِمة رغم ملاحمها الكثيرة والكبيرة أن تشكلّ ندّا للمؤسسة وأزلامها خصوصا وأن ميزان القوى لم يكن مرّة في صالحها، ومن الصعب أن يكون في صالحها في المعطيات الموضوعيّة القائمة المتوفرة.
فكان لا بدّ من استثمار مكامن قوة أخرى، لا تقتصر على حركات وطنيّة محليّة عينيّة بعد أن استُنفذت الإمكانيّات التي استطاعت أن توفّرها، ولم تؤتِ بالثمار المرجوّة، مكامن القوة تلك قائمة أكثر شعبيّا وطنيّا محليّا، وعربيّا قوميّا إقليميّا، وأهليّا مذهبيّا إقليميّا.
المكمن الأخير، الأهلي المذهبي الإقليمي، هم الأهل عصبا ومذهبا في سوريّة ولبنان، وهم الأكثر عددا وعدة ولم يطلهم تشويه الانتماء لا القوميّ ولا المذهبيّ، العرب الدروز أو المسلمون الموحدون في سوريّة ولبنان، هم الغالبيّة العظمى بين الدروز وفيهم أصول الغالبيّة من العائلات الدرزيّة الفلسطينيّة، إذ أن الدروز في فلسطين (123 ألف) يشكلون قرابة ال- 7% من دروز الشرق فقط، وفيهم، في دروز سوريّة ولبنان، المرجعيّة المذهبيّة والاجتماعيّة والسياسيّة العليا للدروز عامة. فكان لا بدّ من خلق “التواصل” مشروعا متكاملا، وإن بقلب المعادلة وابتداء من الأهليّ والمذهبيّ، تعزيزا للهويّة والانتماء الديني والوطنيّ والقوميّ.
ب_ لماذا الدّروز؟!
المسيرة الحياتيّة لأيّ شعب في صيرورتها وسيرورتها وبأوجهها؛ الإنسانيّة والقوميّة والوطنية والسياسيّة والاجتماعيّة، هي لمجموع أبناء الشعب، مهما اختلفت انتماءاتهم الثانوية عقائديا، اجتماعيا، طائفيا ومذهبيا. وقلّما يشار في الأدبيّات إلى حال شريحة من الشرائح بمعزل عن المسيرة الكلّية، إلا إذا حتّمت ذلك دواع موضوعية. فهل هي موجودة في سياقنا؟!
الدُّروز الفلسطينيّون من أبناء شعبنا صاروا أو صُيّروا حالة خاصّة من حالة خاصّة؛ حالة الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة ما بعد وعلى ضوء النكبة وقيام دولة إسرائيل. حالة تحتّم تناولها بحلوها ومرّها ولكن من خلال ترابط لا ينفصم مع فضائهم الكينونيّ الأوسع، أمّتهم وشعبهم، ومن خلال إدراك الإشكاليّة خصوصا القوميّة منها.
وجد الدّروز أنفسهم بين حجارة رحىً عربيّة ويهوديّة تطحن دون هوادة. وبما أنّ المطلوب للبقاء الكريم هو الحفاظ على مواطن ومكامن قوّة وجودنا الحياتيّ وأولّها؛ وحدتنا الوطنيّة. ولتعزيزها كان لا بدّ من استثمار مكامن قوة أخرى، لا تقتصر على حركات وطنيّة محليّة عينيّة بعد أن استُنفذت الإمكانيّات التي استطاعت أن توفرها، ولم تؤتِ بالثمار المرجوّة، مكامن القوة تلك قائمة أكثر شعبيّا وطنيّا محليّا، وفلسطينيّا، وقوميّا إقليميّا، وأهليّا مذهبيّا إقليميّا.
ت_ الدروز لمحة تاريخية
ما من شك أن الاجتهادات الفقهية في المذهب الإسلامي التوحيدي (الدرزي) هي راديكالية في بعض جوانبها، والتخوف من إظهارها إلّا على المعتنقين القادرين من أتباع المذهب، كان وراء الحفاظ عليها سرية خوفا من الملاحقة. هذه السريّة كانت وما زالت سببا ووراء كثرة الاجتهادات حول هذه الجماعة وقد ساهمت كثيرا في خلق البلبلة حولهم وحول معتقداتهم، وبالذات حول انتمائهم دينيا وحتى عرقيا. وقد ساهم الكثيرون منهم ممن كتبوا عن أحوالهم في زيادة هذه البلبلة بإتباعهم “التقيّة” طريقا في أحسن الأحوال.
التقيّة: من اتقاء وهو مبدأ شيعي يعني: “الاستتار بالمألوف عند أهله اتقاء للأذيّة”.
في سنة 765 م. الموافقة لسنة 148 ه. توفي سادس الأئمة الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين أخ الإمام الحسن أبناء الإمام علي بن أبي طالب (ر). بعد وفاة الإمام جعفر الصادق انقسم أنصار آل البيت وهم الشيعة العلوية إلى قسمين: القسم الأول قال بإمامة إسماعيل الابن الأكبر بينما نادى القسم الثاني بإمامة ابنه موسى، فأطلق على شيعة إسماعيل الإسماعيليين.
من سلالة إسماعيل، القائم بأمر الله الفاطمي أول الخلفاء الفاطميين بالمغرب. انشق الدروز عن الاسماعيليين في مصر في أيام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله حفيد الخليفة القائم حفيد الإمام إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق.
هنا ظهر مذهب التوحيد سنة 1017 م. الموافقة 408 ه. وانتشر في المناطق السورية بين الاسماعيليين المعتقدين بإمامة الفاطميين، ولكن الاختلاف في نواح هامة جزأهما. فاعتنقت هذا المذهب قبائل تغلب وربيعة وعليّ وشمر وغيرها من القبائل التي كانت معوانا لأمير حلب سيف الدولة الحمداني في حربه على الروم. واعتنقه كذلك كثير من قبائل تميم وأسد وعقيل و”معروف” ودارم وطي، وفي الكوفة اعتنقته قبيلة المنتفك التي يرجع أصلها إلى قيس عيلان، ومن أسماء بعض هذه القبائل أطلق عليهم لقب “بنو معروف” و”بنو قيس”، واعتنقته كذلك قبيلة كتامة، التي كونت النواة الصلبة لجيش الدولة الفاطمية حين قدومها إلى مصر بقيادة جوهر الصقلي باني القاهرة.
في سنة 420 ه. الموافقة 1029 م. تولى الأمير رافع بن أبي الليل وعشيرته طي المعتنقون مذهب الدولة الفاطمية إمارة عرب الشام إثر انتصاره في معركة “الأقحوانة” القريبة من طبرية في فلسطين، إلى أن انقلبت الآية فهزم مما اضطر أتباعه من قبيلته والقبائل أعلاه العودة عن المذهب إلى مذهب السنّة، ومنهم من حافظ على مذهبه بالكتمان، ومنهم من لجأ إلى الجبال الخالية في لبنان ووادي التيم والجليل. فأطلق على دروز جبل لبنان آل عبد الله وعلى دروز وادي التيم آل سليمان وعلى دروز صفد آل تراب.
غني عن القول إن الاسم الحقيقي للدروز هو “الموحِّدون”، وأما الاسم الشائع “الدروز” فجاء من اسم “نشتكين الدَّرزي” أحد دعاة المذهب الذي ارتدّ لاحقا عن المذهب وقتل على أيدي الموحّدين أنفسهم.
ظل سبر حقيقة المذهب التوحيدي عصيّا على المؤرخين، فاجتهد شيوخهم في الكثير من المناسبات لتبيان أسس المذهب ردا وتوضيحا. في مقابلة صحفية مع الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الموحدين الدروز في لبنان حينها. جاء:
“نورد هنا نص فقرة من تصريح فضيلة شيخ الإسلام الأكبر شيخ الجامع الأزهر المغفور له الشيخ محمود شلتوت الذي نشر على لسانه في 1\آب\1959: لقد أرسلنا من الأزهر بعض العلماء كي يتعرّفوا أكثر على المذهب الدرزي وجاءت التقارير الأولى تبشر بالخير. فالدروز موحدون مسلمون مؤمنون”.
ويضيف أبو شقرا:
“الموحدون الدروز مذهب خاص من المذاهب الإسلامية المتعددة وهو كجميع المذاهب الأخرى وليد اجتهادات فقهية وفلسفية في أصول الإسلام. والمتتبع لتاريخ مذهب الموحدين يرى أنّه يمثل مدرسة فكرية خاصة من مدارس الفكر الإسلامي”
وتقول الدكتورة نجلاء أبو عز الدين:
“إن الدروز جروا على كتمان مذهبهم عمن سواهم. وللتقية دور في هذا التستر. فالتقية هي ستر المذهب إذا تعرض الفرد أو الجماعة للخطر بسبب المعتقد. وقد أذن القرآن بالتقية في ظروف خاصة (القرآن الكريم 16\106 سورة النّحل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وفي الحديث: الأعمال بالنيّات. أما الشيعة فقد جعلوا التقية واجبا في سبيل مصلحة الجماعة. وإلى جانب التقية هناك سبب للكتمان أكثر أهمية وهو الحفاظ على العقيدة كي لا تصل إلى الذين لم يتهيّؤوا لقبولها، فيسيئون تفسيرها ويشوهون حقيقتها ويختلط عليهم ما يعتقدونه.
المثبت تاريخيا، بالقدر الذي يؤخذ التاريخ له إثباتا، والمجمع عليه، إلا من قلّة لا تكتب تاريخا إنّما مراضاة لحكام أو مراضاة لأمراض التبعية التي تعاني منها، المثبت والمجمع عليه أن الدروز عرب عرقا، شيعة إسماعيليون إسلاميون أصلا ومذهبا. أمّا حاضرا فهم أقرب إلى السنّة فقد انقسموا عن الاسماعيليين، كما قيل سابقا، ومالوا إلى السنّة. فهم اليوم بين السنّة والشيعة متأثرون في اجتهاداتهم كذلك بالفلسفة الإغريقية والشرق أسيوية والمصرية والديانات السماوية الأخرى، لكن الأساس هو القرآن الكريم بتفسير باطني للكثير من آياته.
في الأدبيات التوحيدية نجد على سبيل المثال ما يلي:
“فاعملوا بالظاهر ما دام نفعه مستمرا وحكمه مستقرا، واطلبوا الباطن ما دام مشارا إلى مستوره الخفي، والعمل بها مقبول، والثواب مأمول”.
وفي أدبيّة تخاطب المناهضين للدعوة التوحيدية، نجد:
“أفتناسيتم، أيها الغَفلة، من فصول دعائم الإسلام، ما أُمرتم بحفظه والحضّ عليه، أن القرآن مثل لخاتم الأئمة…”
كذلك نجد في أخرى في توبيخ لداعية مرتد:
“وأمّا ما طعنتَ به سيّد الرسل والأمّة، في ذكر أبي لهب عمّه، فما بخس الله، جلّت آلاؤه، بالأنبياء الظاهرين للبشر بمن ارتدّ عن طاعتهم من أهلهم وكفر.. وإنما حداك على ما أجريت إليه، يا قليل العلم، شيئان: أحدهما أن تجعل مدخلا للطعن على دين الإسلام، وسببا لنقض الأنبياء الكرام، والآخر ركاكة عقلك وغلظ فهمك عمّا يتعقّب عليك من المعائب في هذا المقال. وفي إحدى هذه الجرائم ما يوجب قطع بنانك وجد لسانك وهدم أركانك..”
وفي أخرى نجد توجيها لأحد دعاتهم:
“واجمع شمل الموحّدين، وكن لهم في نفاسهم وأعراسهم وجنائزهم على السّنّة.”
تقول الدكتورة نجلاء أبو عز الدين:
“إن العقيدة الفاطمية- الإسماعيلية مفعمة بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة. فالنظريات الفلسفية اليونانية وغيرها من الأفكار المقتبسة من مصادر خارجية أدمجت بفضل التفسير الفاطمي للقرآن في العقائد الإسلامية كما طورها الإسماعيليون الذين قالوا أن للقرآن معنى ظاهرا ومعنى باطنا، وإن التأويل يوصل إلى المعنى الحقيقي للنص. وتفسير المعنى الحقيقي الكامن وراء الظاهر أمانة أوكلت إلى الإمام والراسخين في العلم”.
ويقول كمال جنبلاط:
“إن أساس عقيدتهم قائم على طلب الحكمة فليس سوى الطالبين بمستطيعين قراءة الكتب المقدسة التي تسمى “الحكمة”، إنها امتداد للمدارس الهرمسية اليونانية أو المصرية- مدارس السنّة الباطنية- التي انتقلت إلى التصوف الإسلامي… يبقى بعد ذلك أن الدرزية الحقيقية هي الحكمة العرفانية في اليونان ومصر وفارس والإسلام في آن معا”.
يرى المتتبع للمذهب التوحيدي (الدرزي) أن الأدبيات الفقهية الدرزية المجموعة في ستة كتب لديهم أسموها ” الحكمة” تحتوي اجتهادات فقهيّة متميزة في سيرة الخلق ومراحله ومتميزة في معتقدات أخرى وفي لبّها عقيدة تقمّص الأرواح. من هنا، من الاختلاف الراديكالي عن بقية المذاهب في قضايا كالمذكورة، حافظوا على سريّة اجتهاداتهم خوفا من الملاحقة التي ميزت وما زالت تميز المجتمعات التي لا تتحمّل حرية المعتقد، خصوصا إذا كان في المعتقد ما يناقض، يخالف أو يجتهد في المعتقد السائد.
ث_ مراحل ومحطات
تواجد الدروز في فلسطين
وعددهم تاريخيّا
تواجد الدروز في فلسطين عرقيا هو تواجد القبائل العربية التي انحدروا منها، أمّا مذهبيا فمنذ الدعوة للمذهب في القرن الرابع هجري أواخر العاشر أوائل الحادي عشر ميلادي. بعد هزيمة الفاطميين في بلاد الشام كما ذكر أعلاه انتشر من تبقّى على المذهب في قرى جبل صفد والكرمل والشاغور وعكا وطبرية. تناول هذا الموضوع الكثيرون ممن كتبوا عن الدروز وبسياقات شتى وأجمعوا، وبناء على المصادر المتوفرة على الآتي:
المرحلة \ المحطة الأولى: اعتناق جزء كبير من أهل البلاد الذين سكنوا هذه الديار أواخر القرن العاشر أوائل الحادي عشر الميلاديين المذهب التوحيدي (الدرزي)، جريا على المقولة: الناس على دين ملوكهم، بعد امتداد سلطة الخلافة الفاطمية على البلاد، والمصدر الأساس هو أدبيّاتهم:
الرسائل التي أرسلها دعاة المذهب للأتباع والتي مازالت محفوظة حتى اليوم في كتبهم المعروفة باسم “الحكمة”. وفي كتاب \ مخطوطة: “عمدة العارفين في قصص النبيين والأمم السالفين” المعروف عندهم باسم “المؤلف” للشيخ عبد الملك محمد الأشرفاني من قرية الأشرفية في غوطة الشام.
هذه الأدبيات تجيء على أسماء العديد من التجمعات السكنية الفلسطينية:
الرملة وعسقلان وعكا، وبالأساس قرى في شمال فلسطين منها ما زالت قائمة حتى اليوم ويسكنها الدروز ومنها ما زالت قائمة ولا يوجد بها دروز ومنها ما لم تعد قائمة إمّا بهجرها على مرور الأيام وإمّا إثر النكبة 1948 وهي:
يركا وجث (ما زالتا قائمتين) الكويكات وميماس والحنبلية في الجليل الغربي. دما والسافرية على مشارف كفر كنا في الجليل الأسفل. عين عاث في الشاغور والجرمق في الجليل الأعلى.
يذكر الدمشقي 1256-1327 تواجد الدروز في جبل الزابود (اراضي بيت جن اليوم س. ن.) بالقرب من صفد، وفي البقيعة.
أما العثماني الذي عاش في القرن الرابع عشر، في كتابه: “تاريخ صفد” فيذكر كذلك أماكن التواجد أعلاه.
كذلك يشير الرحالة التركي أوليا تشيلبي الذي كان زار البلاد بين 1649-1670 إلى تواجدهم في نواحي قرية الجش.
المرحلة \ المحطة الثانية: في القرن الثاني عشر الميلادي هاجرت عشائر من قبيلة ربيعة بقيادة المعنيين من شمال سورية لتستقر في الشوف بلبنان والذي يعود إليها الأمير فخر الدين المعني الثاني 1585-1635 والذي بسط سلطانه على شمال فلسطين بين السنوات 1603-1607. دامت هذه السلطة لأبنائه
وأحفاده من بعده على مدى 150 عاما متقطعة. استوطن خلالها الكثيرون من أتباعهم شمال البلاد وعلى خط لوبية شرقا وحتى الكرمل غربا حيث بلغ عدد قراه سابقا الاثنتي عشرة قرية بقي منها اثنتان اليوم، الدالية وعسفيا.
كتب الرحالة موندريا الذي مر في البلاد سنة 1697 بأن للدروز جبال عديدة تمتد من كسروان شمالا حتى الكرمل جنوبا.
المرحلة \المحطة الثالثة: تبدل تواجدهم على مدى الأربعة قرون الأخيرة من الألفية الثانية، بالهجرات والهجرات المعاكسة داخل مناطق سورية الكبرى، تبعا للأحداث والصراعات الكثيرة التي عاشتها المنطقة. وقد شكل الدروز في هذه المرحلة على قلتهم، في شمال بلادنا وحدة واحدة أدارت بعض شؤونها الخاصة، كان مركزها قرية بيت جن مسكن شيخهم الروحي الشيخ حمود نفاع حتى سنة 1753 حيث تنازل عنها لآل طريف، فانتقل المركز لقرية جولس حتى أيامنا.
خلال القرن التاسع عشر تقلص عدد الدروز في فلسطين، إذ هاجروا منها وبالأساس إلى حوران جبل الدروز ويمكن أن نحدد أربعة أسباب رئيسية لذلك هي:
الأول: استيلاء الحركة الصهيونية مدعومة بالفساد العثماني والرجعي العربي المحليّ، على أراضيهم وقراهم كما حدث في المطلّة والجاعونة (روش بينه).
الثاني: الفرار من الخدمة العسكرية التي فرضها “الاحتلال” المصري في الثلاثينيات من القرن المذكور، والعثماني أواخر القرن. مثالا قرية الجرمق.
الثالث: الضرائب المرهقة والتجاوزات كانت سببا آخر للهجرة التي تواصلت في العقود التالية. مثال ذلك: قسم كبير من سكان بيت جن كما تذكر المصادر مشيرة إلى كثرة البيوت المهدمة التي تحولت إلى آثار.
الرابع: الصراعات الحمائلية ولكن بالأساس الطائفية. مثال ذلك: قرية سلامة في الشاغور والشلالة والدامون وبستان والرقطية وجلمة وسماكة وأم الزينات والخربة وحليمة المنصور في الكرمل والمنصورة قرب المغار.
كان عدد المهاجرين كبيرا إلى حد أن كثيرا من القرى أقفرت من ساكنيها وسرعان ما لفها الخراب. وذهب المهاجرون إلى حوران.”
عددهم:
هذا التواجد الذي دام مراوحا بين المد والجزر نتيجة للأوضاع المتقلبة في سورية الكبرى والمنطقة بشكل عام لا يفيدنا بأرقام عن تعدادهم إلا فيما ندر. يقول سعيد الصغير:
بلغ عدد الذين تقبلوا الدعوة الدرزية أيام الدولة الفاطمية أل-700 ألف، رغم ضخامة الرقم حينها وعطفا على عددهم اليوم، يمكن أن يعزى الأمر إلى مقولة: ” الناس على دين ملوكهم” مذهب الدولة الفاطمية حينها، وانحسار العدد طبيعي بعد انحسارها.
أما الإحصاء الذي أجراه الجزّار في جبل لبنان أواخر القرن الثامن عشر فيشير إلى أن العدد يبلغ 60 ألفا.
في القرن الثامن عشر وبالتحديد 1887 يُذكر الرقم 7860 نسمة في فلسطين.
اعتبر العثمانيون الدروز من المسلمين ولذلك لم تهتم الإحصائيات العثمانية بالإشارة لهم بصورة منفردة. أما ولاية سوريا فقد أحصتهم سنة 1880-1881 فكانوا في شمال فلسطين 2752 نسمة.
سنة 1886 في إحصاء لباحث أوروبي (شوماخر): 7360 نسمة في كل فلسطين، منهم في الجاعونة 375 نسمة.
سنة 1896 إحصاء الرحالة فيتال كونت: 1075 نسمة في الشمال.
بالمقارنة بين الإحصاء الذي أجرته ولاية سوريا سنة 1880 والذي أجراه بعد 16 عاما الرحالة كونت فعددهم تناقص إلى أقل من النصف. والتناقص كان في معظم قراهم التي لم ترحل، فانخفض عددهم في يركا من 1280 نسمة إلى 937 نسمة وفي بيت جن من 1215 نسمة إلى 895 نسمة.
أما في القرن العشرين فكان العدد في بلادنا:
سنة 1922: 6928 نسمة. أو 7028 حسب مصدر آخر من أصل 757182 عامة سكان فلسطين، 0.92%.
سنة 1931: 8823 نسمة. أو 9148 حسب المصدر الآخر من أصل 1033314 عامة سكان فلسطين، 0.88%.
سنة 1945: 14858 نسمة مع آخرين من أصل 1810037 سكان فلسطين، 0.82%.
سنة 1949: 13132 نسمة موزعين في القرى الآتية:
دالية الكرمل – 1461، كسرى- 446، عسفيا – 1311، الرامة – 508، شفاعمرو- 745، يانوح – 444، المغار- 1273، كفر سميع- 286، يركا-1731، جث- 213، بيت جن-1534، كفر ياسيف- 59، جولس- 875، حرفيش- 701، ساجور- 384، البقيعة – 664، ابو سنان-497، عين الأسد – …
الدائرة السوداء: مدن
الدائرة: قرى مختلطة طائفيا
المربع: قرى درزيّة
ج_ الدروز أرقام 2020
دائرة الإحصاء المركزيّة
بيان صحافي 22 نيسان 2021*
- مقتطفات.
**في نهاية عام 2020 وصل تعداد السكان الدروز في إسرائيل إلى ما يقارب 147 ألف نسمة (معطى مؤقت) – أي بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ قيام الدولة (14.5 ألف فرد عام 1949). (هنالك معطى آخر في الأدبيّات يتحدّث عن 13,172 نسمة، والعدد 147 ألف يشمل سكّان الجولان الدروز، قرابة ال- 23,000 نسمة. – الكاتب)
منذ قيام الدولة تضاعف عدد الدروز 10 مرّات من 14,500 في سنة 1949 إلى 147,000 سنة 2020 (ناقص سكان الهضبة قرابة ال-23,000 فتكون المضاعفة 8.5 مرّة- س. ن.) الزيادة خلال السنوات كانت بالأساس نتيجة للتزايد الطبيعي؛ ولادات أكثر من وفيّات، وضمّ هضبة الجولان عام 1981. السكّان الدروز يشكّلون 1.6% من مجمل السكّان و7.5% من العرب في الدولة.
**في نهاية عام 2019 كانت البلدات التي تضمّ أكبر عدد من الدروز هي دالية الكرمل (17.1 ألفا) ويركا (16.9 ألفا).
**في نهاية عام 2019، كان عدد الأولاد حتّى ال- 14 ما يقارب ربع السكان الدروز (%25.2). وعند السكان اليهود (%27.6)، وعند السكان المسلمين (السنّة – س. ن.) تقريباً الثلث، (%33.4)، أمّا السكان العرب المسيحيين (هنالك مسيحيّون غير عرب وبالذات أولئك القادمين من الاتّحاد السوفييتي سابقًا وغير معترف بيهوديّتهم – س. ن.) الأطفال منهم تقريبًا الخُمس (%21.3).
**معدّل الخصوبة الكلّيّ للمرأة الدرزية عام 2019 كان يساوي 2.02 طفلاً بالمعدل، مقارنة بالسنة السابقة 2018 حيث وصل لـ 2.16. معدّل الخصوبة الكلّي لدى النساء الدرزيات آخذ في الانخفاض منذ منتصف ستينات القرن الماضي. أعلى معدل للخصوبة تمّ قياسه عام 1964 فكان 7.92 طفلاً لكل امرأة. عام 1990 كان المعدّل يساوي 4.05 طفلًا. وعام 2000 – 3.07 طفلًا. وعام 2010 – 2.47 طفلًا.
** في العام 2019 كان 24,400 نفس محتاج لخدمات اجتماعيّة مسجّل في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعيّة. نسبة المسجّلين في وسط الدروز 168.4 نفس لكل 1000 مواطن، وهو أعلى كثيرًا من المعدّل في الدولة؛ 124 لكل 1000 نفس.
الانتشار الجغرافي: الدروز يقطنون في لواءين بالأساس؛ لواء الشمال (حوالي ال-%80 من السكّان الدروز)، ولواء حيفا (حوالي ال-%19). %98 من الدروز في إسرائيل يقطنون في 19 مجمّع سكّاني، 17 منهم في لواء الشمال واثنان؛ دالية الكرمل وعسفيا في لواء حيفا. هذه المجمّعات هي متجانسة بالأساس؛ في 13 بلدة نسبة الدروز تربو على %95 وأكثر، و-8 بلدات منها (بيت جن، مجدل شمس – الجولان، بقعاثا الجولان، جولس، يانوح جث، مسعدة – الجولان وعين قنيا – الجولان) كل السكّان فيها هم دروزا.
- قائمة البلدات وتعدادها ونسبة الدروز فيها لسنة 2019:
| الاسم | الدروز بالآلاف | النسبة المئويّة % |
| دالية الكرمل | 17.1 | 97 |
| يركا | 16.9 | 98 |
| مغار | 13.2 | 57 |
| بيت جن | 12 | 100 |
| مجدل شمس | 11.2 | 100 |
| عسفيا | 9.5 | 76 |
| كسرى- سميع | 8.4 | 95 |
| يانوح – جث | 6.7 | 100 |
| بقعاثا | 6.6 | 100 |
| جولس | 6.4 | 100 |
| حرفيش | 6.2 | 96 |
| شفاعمرو | 5.8 | 14 |
| البقيعة | 4.6 | 78 |
| ساجور | 4.3 | 100 |
| أبو سنان | 4.3 | 30 |
| مسعدة | 3.7 | 100 |
| الرامة | 2.4 | 31 |
| عين قنيا | 2.1 | 100 |
| عين الأسد | 0.9 | 97 |
- وتيرة التزايد:
في العقد الأخير تدنى معدّل النمو عند الدروز بالتدريج: سنة 2010 كان النمو %1.7 وفي سنة 2015 %1.4 سنة 2019 %1.3، هذا المعدّل أقلّ منه بين السكّان المسلمين (%2.3) واليهود (1.6)، ولكنه أكثر من لدى المسيحيّين العرب (%1).
*عنوان البيان؛ السكّان الدروز في إسرائيل – مقتطف معطيات بمناسبة عيد النبي شعيب 22.04.21
*المقتطف يشمل العدد دروز الجولان والذين أضيفوا عام 1981 يقانون الضم.
*البيان مترجم عن العبريّة ترجمة أمينة طبعًا للمصدر، وهنالك مصطلحات يستعملها البيان لا يتبنّاها الكاتب.
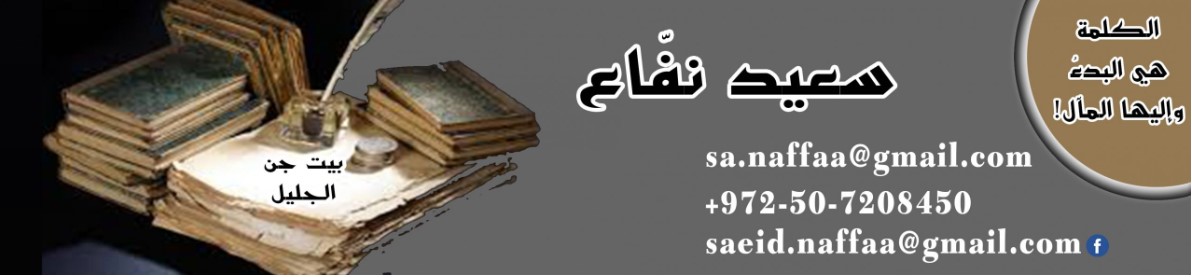 سعيد نفاع
سعيد نفاع