هل ما زالت المراوحة في المكان سِمة حركتنا النقديّة!؟
سعيد نفّاع
لست بصدد الإجابة على هذا السؤال في هذه المداخلة غير المداخلة، ولكنّي سأتركها للقاريء يستنبطها من نقاش كتابيّ جرى بين الناقد البروفيسور إبراهيم طه وبيني قبل سنوات. ورغم إن ذلك صار من تاريخ حركتنا الثقافيّة حسب قول إبراهيم، إلا إني وب- “التآمر” معه رأيت أن أطرح ذلك مجدّدا.
والسبب المباشر الذي حثّني على إعادة الطرح، إني بدأت مؤخرا قراءة كتاب البروفيسور إبراهيم طه الرائع الهام: “البعد الرابع – مساومات سيميائيّة مع الأدب الفلسطيني والعربي”، والذي كان أهداني إياه قبل مدّة وجيزة كاتبا في إهدائه: “إلى الأستاذ سعيد نفّاع السياسي المشاكس والأديب الجامح”، وأبدا لم يذكر أمامي إنّ الكتاب وفي فاتحته والتي وضعها تحت عنوان: “من باب التقديم: عن ثقافة النقد الأدبيّ”، إنه “دابك” فيّ ردّا على “دبكة” سابقة لي فيه، ولم أكن قد رأيت هذا المقال سابقا. وبالمناسبة حين تبادلنا “الدّبيك” لم تكن علاقتنا تتعدّى المعرفة البعيدة!
أمّا السبب الموضوعيّ لإعادة طرح النقاش؛ فهو إنّي أرى وبعد أن قرأت الأطروحات إن الادعاء عن “المراوحة في المكان” ما زال مسألة فيها نظر وعمليّا ومقلقا، ويجب علينا أن نستفزّ نقّادنا لأن حركتنا الثقافيّة بحاجة ماسّة لهم.
أدعو النقّاد والكتّاب لمواصلة الحوار في هذا الشأن لأهميّته. وعلى رأي بروفيسور طه، المطروح كذلك اليوم، إن الأزمة عندنا كانت وما زالت أزمة قراءة ونقد وليست أزمة إبداع… وأتوخى من نقّادنا أن يدلوا بدلوهم في الموضوع لنشره في العدد القادم، لجعل الحوار في هذا الموضوع وفي غيره محورا من محاور شتّى “تستضيفها” مجلتنا تباعا.
فقد كتب بروفيسور طه:
عيب علينا ما يحدث في نقدنا الأدبيّ
يبدو أنّنا لا نعاني من أزمة في إبداعنا الأدبيّ بقدر ما نعاني من أزمة عميقة في النقد. ليتها كانت أزمة عارضة. الحقيقة أنها حالة من حالات الموت السريريّ. والنقد هو الوجه العمليّ للقراءة. فإذا كان النقد قد تراجع إلى هذا الحدّ من الركود والجمود فهذا يعني بالضرورة أنّ هناك تراجعًا مقلقًا في القراءة. وتردّي أحوال القراءة مردود إلى اعتبارات كثيرة. أوّل هذه الاعتبارات وآخرها، في ظنّي وتقديري، هو غياب “ثقافة” القراءة أو ذهنيّة المطالعة المتوارثة. ووضع طلاب الجامعات في هذا الشأن، حتى أولئك الذين يدرسون في أقسام اللغات والآداب، ليس أحسن حالا!
ليست ثقافة الاستهلاك، التي هي أبرز مخلّفات الثورات التكنولوجيّة المتلاحقة، سببًا مباشرًا أو هي ليست عاملا حاسمًا في هذه الأزمة، كما يعتقد بعضهم. ولو كان الأمر كذلك لكانت دول الغرب هي أوّل من يعاني وبال هذا التقدّم وانعكاساته على استهلاك الأدب. والحال عندهم ليست كحالنا مثلما نرى ونسمع. لأسفي الشديد، لم تتوغّل إلى خطابنا النقديّ، حتى هذه اللحظة، آليّات نظريّة أو عمليّة رقميّة لبيان حجم القراءة عندنا وقياس مدى استهلاكنا للأدب. لا نعرف مثلا ما هي الأعمال الأدبيّة التي تتصدّر “قائمة المبيعات” كلّ عام. ولم نسمع عن أيّ توثيق رسميّ لهذا الاستهلاك يشمل كلّ المعلومات المتعلّقة بعدد الطبعات والنوع الأدبيّ والفترة الزمنيّة وغيرها من المعلومات الضروريّة.
يُنشر عندنا باستمرار الكثير من المجموعات القصصيّة والشعريّة، بعضها لكتّاب وشعراء معروفين وبعضها الآخر لكتّاب وشعراء واعدين يملكون الموهبة بالفطرة. لقد قرأت الكثير منها، ومن المؤسف حقّا ألا تنال استحقاقها من الاهتمام والنقد حتّى يومنا هذا. أتوجّع كثيرًا حين أرى هذا الإبداع ولا أرى نشاطًا نقديّا يصاحبه برؤية دقيقة ومتأنّية. يبدو لي، بالمعاينة الذاتيّة، أنّ نسبة من يترجمون دراساتهم الأكاديميّة إلى نشاط نقديّ عمليّ متدنّية إلى حدّ يثير الدهشة. ويبدو لي أيضًا أنّ ما يُنشر من نقد أدبيّ أكاديميّ عميق لا يتجاوز مقالتين اثنتين شهريًّا في أفضل التقديرات؟!
أين أصحاب الشهادات العليا، أين حملة الماجستير والدكتوراة من أقسام اللغات والآداب وهم يتخرّجون بالمئات كلّ عام من كلّ الجامعات؟!
أين هؤلاء وأين ما يدرسونه وما يمتلكونه من أدوات؟
كان أدبنا في العقود الثلاثة الأخيرة يشهد حركة نقديّة يقظة ونشطة رغم قلّة الأكاديميّين من حملة الماجستير والدكتوراة. واليوم رغم كثرتهم نشهد تراجعًا مقلقًا غير مبرّر! والأمر لا يخلو من مفارقة غريبة.
فما علّة هذا التردّي؟! أليس هذا من العيب؟
إنّ ما يمارس من نقد أدبيّ الآن هو انتقائي، ولا بأس في ذلك. لكنّنا نحتاج إلى جهد شامل لغربلة الغثّ من السمين. ليست هناك مشكلة في الانتقاء. المشكلة في أن يظلّ هذا الانتقاء الخيار الوحيد في “نشاطنا” النقديّ. أدرك جيّدًا أنّ المسألة ليست بهذه البساطة. لكنّي أعتقد أنّ هذا التراجع مردود إلى عقليّة النكوص إلى حدود الخاصّ والعزوف عن العامّ والمرابطة في دائرة الذات.
الماجستير والدكتوراة هي أدوات لتحسين الحالة الماديّة الخاصّة أو هي لتيسير التقدّم المهنيّ ولا بأس في ذلك. صحيح أنّ النقد لا يُشبع معدة جائعة، لكن من قال بأنّ المساهمة في إحياء الحراك النقديّ لا تكون إلا على حساب المنفعة الخاصّة؟ ولا أبالغ إذا قلت بأنّ مساهماتي النقديّة المكثّفة في سنوات الثمانين كانت تأشيرة دخولي للعمل في الجامعة عام 1990. حين أنهيت دراستي الجامعيّة للّقب الأول عام 1982 وانتقلت بعدها للّقب الثاني (الماجستير) بدأت رحلة طويلة من النشاط النقديّ مستعينًا بما كنت أجمعه من أدوات نقديّة أثناء هذه الدراسة. أذكر أنّي في هذه الفترة بالضبط كتبت مقالة نقديّة حول قصّة للكاتب مصطفى مرّار كانت قد نشرت في جريدة الاتحاد. وكنت عندها في بداية مشواري النقديّ أنقل ما أدرسه من نظريات في قسم الأدب العام والمقارن في جامعة حيفا إلى مجال الدراسات النقديّة التطبيقيّة. كانت هذه النظريّات والأدوات قد منحتني القوّة والجرأة ما جعلني في تلك الفترة المبكّرة جدّا من مشواري النقديّ أن أشنّ هجومًا كاسحًا على القصّة كما لو كنت عميد النقد العربيّ! أذكر أني قلت، مدفوعا بحماس الشباب، بأنّها لا تسمّى قصّة إلا من باب المسامحة. وبالعودة إلى تلك المقالة التي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن ثلاثين عامًا، أعترف ببعض التجنّي ولا يشفع لي إلا جموح الشباب في تلك الفترة.
على العموم، الجامعة تقدّم حزمة من الأدوات لا حقّ لأحد في وأدها أو إضاعتها. ما أحوجنا إلى ثقافة نقديّة عامّة يكون النقد الأدبيّ الجريء فرعًا من فروعها. نحن نحتاج إلى نقد جريء صريح بعيدا عن الطبطبة والمحاباة. نريد نقدًا يبقي حركتنا الأدبيّة في حالة يقظة مستمرّة واستنفار وتوثّب. ويل لشعب لا يخرّج إلا ناقدًا واحدًا على رأس كلّ عقد من الزمان، والكتّاب والشعراء عندنا يعدّون بالعشرات! تنظر حولك ولا ترى مقابل هذا العدد المشرّف من المبدعين إلا ثلاثة أو أربعة نقّاد يمارسون نقدًا مترفًا على استحياء في فترات متباعدة! ولن ننهض من سرير الموت إلا بجهد هؤلاء الخرّيجين الجامعيّين. فأين هم؟!
عن موقع الجبهة 30.8.2014
ورددت:
البروفيسور طه عاب علينا “نقدنا” دون ان يرينا طريق الخروج من العيب!
طرح بروفيسور ابراهيم طه في ملحق الاتحاد 2014\8\29 موضوعا هامّا جدا تحت عنوان “عيب علينا ما يحدث في نقدنا الأدبي”، لكن الطرح جاء أقرب إلى “أضرب الخميرة في الحيط يا تلصق يا تعلّم”، وبروفيسور طه أقدر كثيرا من الاكتفاء بضرب الخميرة، ولم يفعل.
يقول طه: اننا نشهد اليوم تراجعا مقلقا غير مبرر في النقد، وأن هذا لا يخلو من مفارقة غريبة، رآها في وجود النقد سابقا مع قلة الأكاديميين وتراجعه مع كثرتهم، ثمّ يخلص إلى أن هذا التراجع عائد إلى عقليّة النكوص إلى حدود الخاص والعزوف عن العام والمرابطة في دائرة الذات، ويتساءل عن علة هذا التردّي.
يعوّل طه في معالجته على إصحاب الشهادات العليا اعتمادا على الأدوات التي يملكون في مجال الدراسات النقديّة التطبيقيّة بحكم دراستهم، لوضعنا في طريق الخروج من هذا العيب، ويلومهم باستحياء على كونهم لا يستعملونها إلا أدوات لتحسين الحالة الماديّة الخاصة أو تسيير التقدّم المهني ويرى أن لا بأس في ذلك ولكن…
من نافل القول أن ليس كل مثقف حامل شهادة وليس كل حامل شهادة مثقّفا، فالثقافة الحقيقيّة حسب تصوري هي، في جانب هام منها، مدى استعمالها في العام استعمالا إيجابيّا وإلا ستبقى يتيمة أو صاحبها ثاكلا، فحملة الشهادات الجامعيّة وفي كل الشعوب ينقسمون إلى “مثقفين” و”متعلمين” والمثقفون ينقسمون إلى قسمين مثقفون لذواتهم ومثقفون لذواتهم ومجتمعاتهم، وتتناسب ثقافة الشعوب طرديّا وعكسيّا في بعض جوانبها، حسب التناسب بين المثقفين لذواتهم ولمجتمعاتهم من جهة والمثقفين لذواتهم والمتعلمين من الأخرى وبغض النظر عن الشهادات.
وإن لم تتقدم الحركة الثقافيّة بكل مركباتها وأوجهها في كل شعب أو أمة الصفوف بخطوات ف- “كفك على الضيعة”، والحاصل عندنا في العقود الأخيرة هو أن “الحركة الثقافيّة” وفي أحسن أحوالها تسير في الصفوف وأحيانا المتأخرة منها وبكلّ ما في هذه الصفوف من عاهات ولا تلتفت إليها حتى، وعلى طريقة “حط راسك بين الرؤوس ونادي يا قطّاع الرؤوس”.
ويكفيك كان أن تتابع محاولات إعادة تشكيل اتحادات الأدباء مؤخرا لتتأود شمسيّا وأرضيّا أمامك الحالة التي يصفها طه بعقليّة النكوص إلى حدود الخاص والعزوف عن العام خدمة، والمرابطة في دائرة الذات، ولكنها ذات من نوع آخر ليس الذات الشرعيّ تطويرها وحمايتها بل تلك التي يصحّ فيها القول: “من بعد ذاتي الطوفان” وأقصى تسوية أقبلها إمّا أنا أو مُحازبي أو لا أحد و- “يا خّرّيبة يا لُعّيبة”.
هذا، وما دام الكثيرون من حملة الشهادات لا يتوانون عن حمل العصي والحجارة أو في أحسن الأحوال يغضون الطرف عن حملتها في “دواحس وغبراوات” عوائلهم في كل انتخابات محليّة غير قابلين فوز الفريق الآخر، فكيف لنا أن نقبل الرأي الآخر وكم بالحري إذا كان هذا الرأي يطولنا سلبا؟ وما دمنا نعلّي مراتب حليفنا وإن كان من السافلين ونمرغ في التراب أنف خصمنا وإن كان من العالين ليتبدل هذا بذاك في أول انتخابات، فكيف لنا أن نمارس النقد، هذه الظاهرة الحضاريّة؟
ربّ سائل: إلى أين تورِد إبلَك بهذا الكلام؟
النقد أداة تشذيب للحراك الثقافي ليس فقط في شكل انتاجه الفنيّ وإنما في دوره المجتمعي، لا أنوي في هذا السياق الدخول في حقل ألغام ربّما لا أخرج منه سليما (حفاظا على ذاتي!)، ولكن ما أود قوله هو أن التشذيب مؤلم والمتحملون الألم قلّة في مجتمع كمجتمعنا حتى لو كان من نوع الألم العلاجيّ.
وهنا لا بدّ من لفتة عابرة، في البدء كان الانتاج الإبداعيّ ثمّ جاء النقد لهذا الانتاج واضعا معايير حسب مواصفات الانتاج القائم، فمثلا الانتاج الثقافيّ عند العرب بدأ قرونا قبل أن يتطور النقد، أن يتحول النقد إلى معايير جافّة ففي ذلك جفاف ينابيع الإبداع، وهذا بحدّ ذاته موضوع للنقاش على ضوء ما يروح إليه البعض من محاولة “نمذجة” الإبداعات حسب قوالب وضعها النقاد متناسين أن هذه القوالب “صُبّت” أساسا على انتاجات وليس العكس.
النقد ليس مهمّة سهلة بطبيعته، فهو تشذيب مؤلم كما أسلفت، فكم بالحري في مجتمعات كمجتمعاتنا هذا حال مثقفيها ومتعلميها، “استفزاز” بروفيسور طه حملة الشهادات لن يزيل عنّا ومنّا هذا العيب ولن يوردنا نواصي الطرق للخروج، ولذا أعتقد أنه “يعيب علينا ولا يدلنا على طريق الخروج من عيبنا”، ومرة أخرى ليس لأنه ليس بقادر وربمّا لأنه أرادها ضربة خميرة، على ما استنتج.
ما هو حاصل اليوم في هذا الباب معلوم للكل و”النقد” الذي نشهد هو استعراض انتاجات يغلب عليها في الكثير من الأحيان باب “حُك لي في هذا المكان فأحك لك في مكان آخر” أو في لغة العصر “ليّكلي أليّكلك”، وبعضها يخلو كليّا من أي ملاحظة سلبيّة وفي الأخرى بعض شذرات نقديّة هنا وهنالك كرفع عتب “لا تشبع من جوع ولا تروي من عطش”.
ولا يمكن أن يتناول المرء هذا الموضوع دون أن يمرّ على المنابر الأدبيّة عندنا على قلتها، فالمراقب أو المتابع يلاحظ دون عناء ال-” مونوبولات” المعطاة والممنوحة فيها حسب العلاقات والأسماء والانتماءات وليس حسب مستوى الانتاج، وهذا بحدّ ذاته نوع من “النقد” غير المباشر الذي يأخذه المحرر على عاتقه ولكن من “الطاقة” وليس من “الباب” وهو تصنيفيّ، قواعده أبعد ما تكون طبعا عن النقد الذي نرمي أليه.
كما استطاع بروفيسور طه، بغض النظر عن موافقتي معه أو عدمها، وضع الأصبع في مكان، يستطيع كلّ منّا أن يضعها في مكان آخر، وعليه أرى أنّ البليّة الكبرى هي المظاهر التي سقت أعلاه، وأعتقد أن الطريق للخروج من هذا العيب هو في المساهمة في تنظيم الحركة الإبداعيّة (ولو في عشرة اتحادات!) وليس الوقوف موقف المراقب الواعظ خارج التنظيمات ومهما كانت الحجج.
الناقد معرّض وهذه حالنا أن “يُبحش على قبر جدوده” وخوفا منه على جدوده وراحة لهم في قبورهم يفضّل ال-“ابعد عن الشرّ وغني له”، وخصوصا أنه لن يستطيع أن يصمد أمام الجحافل “لفيس- بوكيّة” القابعة له بالمرصاد. الاتحادات قادرة أن توفر الآليات ليس فقط للإبداع وإنما لحماية النقّاد بإعطائهم الغطاء إذا أحسنت تنظيم الصفوف ورُفدت بكلّ أو معظم أولئك الذين راقبوا انطلاقها مؤخرا دون أن يعطوا هذا الحراك أدنى اهتمام ولكل أسبابه، وحتى دون أن يكلفوا أنفسهم عناء السؤال، فمن أصل ما يربو على ال-500 مبدع عندنا لم يساهم إلا أقل من 200 مبدع في إعادة البناء، وما شاب إعادة التنظيم (ولادة اتحادين) من شوائب صحيح أنه دليل آخر على حال حراكنا الثقافيّ، لكن هذا لا يعطي الحق لأحد أن يتخلّف مكتفيا بالمراقبة أو رغبة في أن “يبقى مع سيده بخير ومع ستُّه بخير”.
أرى أن تنظيم حراكنا الثقافيّ والفعل فيه يمكن أن يشكّل نقلة نوعيّة أو على الأقل بداية عودة عن الركود والجمود والنكوص التي أشار إليها بروفيسور طه وكذلك في مجال النقد، فإذا لم يُسهم المبدع في الحراك الثقافيّ الميدانيّ فكيف له أن يتصدّر مقدّمة الصفوف كدوره المنوط به تاريخيّا؟ وإساسا كيف ستصل كلمته إلى الناس إذا لم يصل هو إليهم؟
وكيف للناقد أن يشذّب عن بعد؟ فالتشذيب لا يكون إلا عن قرب (من داخل أغصان الشجرة)، وسيجد عندها السند في كثير من فروع الشجرة الذي يحفظ له كرامة “قبور جدوده”.
سعيد نفاع
20.9.2014
وردّ طه في مقدّمة كتابه الآنف “البعد الرابع”:
تشذيب الحركة الثقافيّة والتنظيمات الأدبيّة
قرأت تعليق الأستاذ الكاتب سعيد نفّاع على مقالة عن أزمة النقد الأدبي كنت قد نشرتها في الاتّحاد يوم 29/8/2014، وفهمت أنّ الأستاذ نفّاع “يتّهمني” بأنّي “أعرف وأحرِف”، أو كأني لا أقول من الحقيقة إلا ربعها أو أقلّ من ذلك بكثير. يبدو أنّ الأستاذ نفّاع “مجمور” من بعض الكتّاب والمثقّفين والمتعلّمين حملة الشهادات. إذا كان قلبك “مجمورًا” فقلبي مسجور، وقد قلت هذا الكلام وكتبته مرارًا. قلته وعانيت منه وما زلت، لكنّ “المبلول لا يخاف الندى”. ولو لم تكن مقالتي، تلك التي استفزّت الأستاذ سعيد، غير “صرارة أسندت خابية” لكفاها ذلك. ثمّ أليس المثل الذي يقول “القطعة ولا القطيعة” صحيحًا في هذا العهد البائس يا أستاذ سعيد؟!
كلّ ما فعلته في تلك المقالة نابع من حرصي على “تشذيب الحركة الثقافيّة” على النحو الذي يريده الأستاذ نفّاع ويريده كلّ واحد منّا. والتشذيب يتبعه تهذيب كما يقول أبو حنيفة. ليست الشهادات وحدها هي الحلّ “لتشذيب الحركة الثقافيّة” ولا لتهذيبها، وهذه مقولة صحيحة تمامًا. فبعض الكتّاب وحملة الشهادات، حتى وإن كانوا “منظّمين” في تنظيمات وأحزاب وأطر على اختلاف أنواعها، لن تطعّمهم كتاباتهم ضدّ السقوط ولن تسعفهم شهاداتهم في قول الحقّ إلا إذا كانوا جُبلوا على ذلك أصلًا.
كان حديثي في تلك المقالة عن قضيّة عينيّة محدّدة وهي ضرورة تنشيط الحركة النقديّة الأدبيّة والانتقال بها من حالة العوز إلى حالة من حالات الغنى، من حالات الارتجال والفوضى إلى ضبطها بالعلم وتنظيمها بالمعرفة. وأنا هنا أفرّق بوضوح بين التنظيم في ذاته وذهنيّة التنظيم أو ثقافة التنظيم. ما أدعو إليه هو “تنظيم” حركتنا النقديّة وفق ضوابط معرفيّة متخصصّة، دون أن تكون العلميّة والمعرفيّة التي أعنيها عيبًا أو ردف العيب أو جملة “معايير جافّة”. ما عنيته في تلك المقالة هو النقد الأدبيّ حصرًا بوصفه فنّا توصيفيّا لا يُشذّب ولا يُهذّب إلا بأدوات العلم والمعرفة.
أمّا النصّ الأدبيّ، بوصفه فنًا إبداعيًّا، فيحتاج إلى قدرة قبليّة فطريّة موهوبة، قبل أيّ شيء وبعده، وأظنّه لا يُكتسب بالعلم وإن كان يُصقل به. وهذه القدرة الموهوبة، مثلما أسلفت، لا تكفي وحدها للممارسة النقديّة الجدّية المجدية. ولذلك استفززت الهمم، همم أولئك الذين اكتسبوا المعرفة وامتلكوا ناصيتها وهم كثر! هذا ما قلته وهذا ما أصرّ على قوله دون تأتأة. اعتقدت وما زلت أنّ أدبنا يحتاج باستمرار إلى مرافقة علميّة متأنيّة بأدوات تتلاءم مع خصوصيّة هذا الأدب. إنّ الربط العفويّ بين الشهادات والأكاديميا من جهة و”الجفاف” من جهة أخرى لا يخلو من تجنٍّ. فبعض النقد النصّيّ والأكاديميّ، يفوق بحلاوته وطلاوته تلك التي تتميّز بها النصوص المنقودة نفسها. وقد تجد مثل هذا النقد الأكاديميّ، كبعض النصوص الأدبيّة التي تُنشر في “الاتحاد” وفي غيرها، فِجّا يوجع البطن! هذا موجود وذاك موجود.
على العموم، يصعب عليك ألا تتّفق مع الأستاذ سعيد نفّاع في مداخلته، في توصيفه للحالة الثقافيّة وتشخيصه لأسباب الأزمة التي تمرّ بها. وليس من السهل النأي بالنفس عن المرارة التي يترافع بها ضدّ الشهادات ومن يحملونها. لكنّنا نختلف معه في الدواء الموصوف. يعتقد الأستاذ نفّاع “أنّ الطريق للخروج من هذا العيب هو في المساهمة في تنظيم الحركة الإبداعيّة (ولو في عشرة اتحادات!) وليس الوقوف موقف المراقب خارج التنظيمات”.
أنا أعلم علم يقين أنّ الأستاذ سعيد نفّاع على قدر كبير من الدراية والتجربة الطويلة، وهو ليس ساذجًا ليؤمن أنّ عيوب حركتنا الثقافيّة ستزول كلّها بإقامة اتّحاد للكتّاب ولا بعشرة اتّحادات. أظنّ أنّ خيبة الأمل التي أصيب بها الأستاذ نفّاع وهو يسعى لتنظيم الكتّاب في اتّحاد يجمعهم ويمدّهم بالعزيمة ويشحذهم بالهمّة المتوثّبة هي وراء هذه المرارة التي يتحدّث بها وبحقّ. ليت هذه الاتّحادات كانت قادرة على أداء دور المخلّص من بؤس حالتنا الثقافيّة. الحقيقة أنني لا أعرف وصفة سحريّة واحدة مجرَّبة تنجينا من هذا التردّي وترفعنا إلى السطح، لا هذه التنظيمات التي يعوّل عليها الأستاذ نفّاع بكثير من الثقة ولا غيرها. ولا أعرف أحدًا يؤمن أنّ هذه الروابط والاتّحادات هي عصا موسى التي تقلب السحر على الساحر، بقدرة قادر، قبل أن يرتدّ إليه طرفه.
وأخشى ما أخشاه ألا تكون هذه الاتحادات أفضل من عصا غشيمة، لا تصلح إلا للهشّ على الغنم، كهذه التي يحملها كلّ راعٍ من رعيان كابول أو بيت جن. لأسفي الشديد، أقول هذا الكلام وقد جرّبنا هذه الوصفة من قبل أكثر من مرّة. لا أحد ينكر ما لهذه التنظيمات من قدرة نظريّة على التحريك والتفعيل والتحفيز والتمثيل. وقد تكون من الضرورات الواجبة، غير أنّ تلك التنظيمات ستظلّ عقيمة ما لم تشحنها الرغبات الصادقة بالعمل والمساهمة غير المشروطة وغير المأجورة.
لقد كنت فيما مضى عضوًا مؤسّسًا وفاعلا في اثنين من هذه التنظيمات: رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين التي أقيمت في الناصرة وكانت، كما يعلم الأستاذ نفّاع، موصولة بالحركة التقدميّة في ذاك الوقت في أواسط سنوات الثمانين. وبعدها بسنوات قليلة، في مطلع سنوات التسعين، على ما أذكر، دعاني الشاعر المرحوم سميح القاسم للمشاركة في إقامة “اتّحاد للكتّاب” وتفعيله على نحو يليق بنا، وقد كان هو رئيسًا له (أو أمينًا عامّا؟). والنتيجة معروفة في الحالتين.
إنّ التقاطب الذي حصل بين تلك التنظيمات في تلك الفترة جعلت بعض الفِرق النقديّة التابعة لكلّ فئة تعلّي مراتب الحليف وإن كان من السافلين وتمرغ في التراب أنف الخصم وإن كان من العالين كما يقول الأستاذ نفّاع. وصديقي الدكتور نبيه القاسم يشهد على ما أقول. لا تنفع التنظيمات إذا فُقدت النيّة الصادقة والرغبة الفطريّة في العطاء بقدر ما تنفع هذه النيّة وهذه الرغبة إذا فُقدت التنظيمات. أقول بكلّ أمانة: مثلما لم تمنحني تلك التنظيمات، وأنا في داخلها، ما لم أكن أملكه في الأصل هكذا لم تمنعني وأنا خارجها من العمل والعطاء بغير حساب. وأقول الصدق أيضًا إنّ ما رأيته من صراعات وصدامات في هذه التنظيمات يكفي حتى لا أضع كلّ بيضاتي في سلّة واحدة، على نحو ما تفعله يا أستاذ سعيد في التعويل المطلق على اتّحادات الكتّاب بكثير من الرغبة وقليل من الحظّ. وأنا أحيّيك على هذه الشحنة من التوثّب.
ولأنّ الأستاذ سعيد يكاد لا يؤمن بالقدرة على العمل خارج هذه التنظيمات أودّ أن أذكّره وأذكّر أنفسنا بتجربة الأستاذ محمّد نفّاع وهو نموذج يُحتذى في هذا الباب. وهو يعطي ما يعطي دون دافع من رابطة أو وازع من اتّحاد. هذا في زمن لا يفتح فيه بعض الكتّاب فمه قبل أن يأخذ أجرته كاملة، حتى أنّ بعضهم يبدأ بتشغيل العدّاد منذ لحظة خروجه من البيت!
واسمح لي يا أستاذ سعيد أن أذكّر بتجربتي الشخصيّة وما أقدر على فعله دون أن أكون موصولا بأيّ تنظيم أدبيّ. وكلّ ذلك إلى جانب المهامّ الأكاديميّة الأخرى الملقاة على كلّ أستاذ جامعيّ، وهي ثقيلة وسمجة في كثير من الأحايين. صحيح “لا يشكر نفسه إلا إبليس”، لكنّي لا أطلب الشكر، وإنّما أبتغي الحقيقة. والحقيقة التي أعرضها كما ترى تثبت أنّ التنظيمات الأدبيّة ليست شرطًا قبليّا لكلّ نشاط. أقول هذا الكلام وألوم نفسي على تقصيرها، وإن كنت لا أحمّلها وزر العاصين.
- أقوم بتدريس الأدب الفلسطينيّ في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة حيفا في مساق كامل ومستقلّ على امتداد خمسة وعشرين عامًا باستمرار منذ بداية عملي في الجامعة، علمًا بأنّ الجامعات تحضّ أساتذتها على تغيير المساقات كلّ ثلاث سنوات على الأكثر.
- تلبية لنداء الأستاذ محمد نفّاع في حزيران 2010 حرصت من موقعي في رئاسة قسم اللغة العربيّة وآدابها في جامعة حيفا على إقامة مؤتمر سنويّ يعالج جانبًا من جوانب الأدب الفلسطينيّ كلّ عام. وقد شارك فيه حتى الآن العشرات من خيرة كتّابنا على مختلف انتماءاتهم الفكريّة والأدبيّة وما زلنا مستمرّين في هذا النهج.
- أكتب باستمرار في الاتّحاد وغيرها من المنابر عن أدبنا الفلسطينيّ بأدوات أكسبتنيها الجامعة، وأرجو أن تكون مساهماتي هذه قد تركت أثرًا ما على تطوّر هذا الأدب بعد ما يزيد عن ثلاثة عقود من العمل المتواصل في هذا المجال.
- أشارك في كلّ ندوة أدبيّة أو مؤتمر يُعنى بأدبنا يدعونني إليه إن كان في الداخل أو في الخارج.
- أحثّ طلابي في الدراسات العليا باستمرار على كتابة أطروحاتهم للماجستير والدكتوراة عن أدبنا الفلسطينيّ. وقد أُنجزت بالفعل دراسات قيّمة في هذا الاتّجاه وإن كانت على قلّة.
أنا أتّفق معك بأنّ مظاهر العوج موجودة في كلّ مكان وهي جزء من كلّ حراك ثقافيّ أو سياسيّ أو أدبيّ أو دينيّ، أو كائنًا ما كان… أنت تعرف، وأنت سيّد العارفين، أنّ “كلّ ذقن وإلها ماشطة”. إذا كانت هناك ذقون فهي بالضرورة تحتاج إلى “ماشطات”، وهنّ كما تعلم لا يمشّطن لا لوجه الله ولا لوجه العبد! هكذا علّمتنا الحياة.
لقد كبرنا على الرومانسيّة، فلم تنفعنا في البدايات وهل ستنفعنا الآن؟ لن نغيّر الكون بجرّة قلم أو قلمين وستظلّ هذه العقليّة مستمرّة في كلّ مناحي الكون ما استمرّت الحياة فيه. لا نسعى إلى اجتثاث هذه الظواهر من أصلها، وإن كنّا نرجو ذلك، لأنّها جزء من طبيعة البشر أينما حلّوا وأينما ارتحلوا. إنّ مطلب الساعة هو الحدّ من آثار هذه الأوبئة وتحجيم مردودها بضبطها في آليات ومعايير. وهذا ما يدعو إليه الأستاذ نفاّع نفسه وما دعوت إليه في تلك المقالة بالضبط. لكنّه يعتقد أنّ “الاتحادات قادرة أن توفر الآليات ليس فقط للإبداع وإنما لحماية النقّاد بإعطائهم الغطاء إذا أحسنت تنظيم الصفوف ورُفدت بكلّ أو معظم أولئك الذين راقبوا انطلاقها مؤخّرا دون أن يعطوا هذا الحراك أدنى اهتمام”.
على كلّ حال، “أنا أوّل من طاع وآخر من عصى” يا أستاذ سعيد! لست من المثبّطين، وأرجو أن تخيّب الأيّام ظنّي في هذه التنظيمات.
كتاب البعد الرابع… مجمع اللغة العربيّة 2016، إبراهيم طه.
*ملاحظة: البروفيسور طه اليوم عضو بارز وفاعل في الاتحاد!
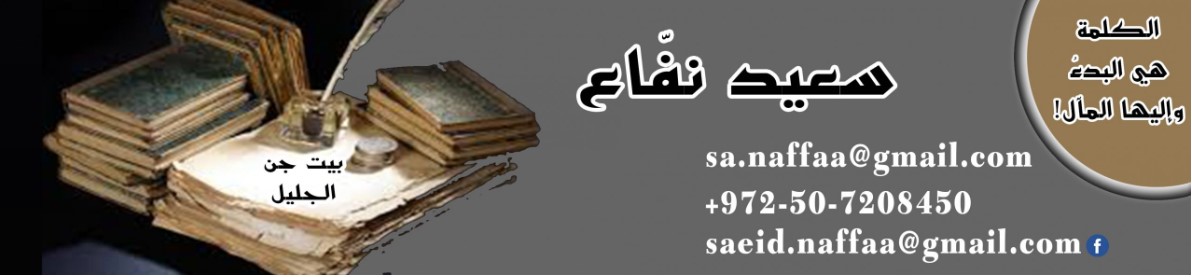 سعيد نفاع
سعيد نفاع